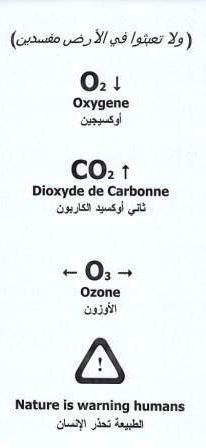التوطين - Page 6
| Article Index |
|---|
| التوطين |
| Page 2 |
| Page 3 |
| Page 4 |
| Page 5 |
| Page 6 |
| Page 7 |
| Page 8 |
| Page 9 |
| Page 10 |
| Page 11 |
| Page 12 |
| Page 13 |
| Page 14 |
| Page 15 |
| Page 16 |
| Page 17 |
| Page 18 |
| Page 19 |
| Page 20 |
| All Pages |
صفحات من مذكرات "أبو أيّاد":
"فلسطيني بلا هوية"
o حرب الأشباح بين الاستخبارات الإسرائيلية وفتح.
o هكذا قتل الإسرائيليون أبو يوسف وكمال عدوان وكمال ناصر.
o أبو إيهاب هو رئيس منظمة أيلول الأسود.
o تفاصيل عملية ميونيخ تنشر لأول مرة.
o كدت أقتل مرتين أثناء معركة الكرامة.
o قال لي عبد الناصر: إن دويلة في الضفة وغزة خير من لا شيء.
o كيف تمت تصفية عناصر المخابرات الإسرائيلية في مدريد ونيقوسيا.
o ثغرة الدفرسوار: كيف حصلت؟ ولماذا لم تقاوم؟
o السلام هو المطلوب.. ولكن كيف؟
المستقبل 23 ايلول 1978 العدد23
اليوم تصدر جريدة "الوطن" في الكويت وهي تحمل الفصل الأول من مذكرات صلاح خلف "أبو أياد". وفي الوقت نفسه تنشر "المستقبل" بإذن خاص من "الوطن" خلاصة لأبرز فصول الكتاب..
وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أحد قادة المقاومة الفلسطينية "التاريخيين" على نشر مذكراته... وفي هذه المذكرات التي ستصدر في كتاب عنوانه "فلسطيني بلا هوية". يجيب أبو أياد عن الأسئلة حول بداية الحركة الفلسطينية وأيديولوجيتها وتنظيمها وحول الفدائيين ونشاطاتهم السرية وغير ذلك من الأسئلة التي ظلت حتى الآن بلا جواب صادر عن مسؤول مأذون له. وأبو أياد يتصدى في مذكراته للأخطاء التي ارتكبها رؤساء المنظمات الفدائية وللصراعات التي ما انفكت تنخر منظمة التحرير الفلسطينية وتعيق عملها.
وبصفته عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح فإن أبو أياد يضطلع بمسؤوليات متعددة بينها مسؤولية تسوية المشكلات الدقيقة مع مختلف رؤساء الدول. وهو يكشف تفاصيل المحادثات السرية التي أجراها – في أحيان كانت عصيبة – مع عبد الناصر والملك فيصل والرئيس الليبي القذافي والرئيس السوري حافظ الأسد.
وأبو أياد إلى ذلك جوالة كبير وهو يورد تفاصيل زيارته للصين وفيتنام وكوبا والاتحاد السوفياتي ومحادثاته مع شو ان لاي والجنرال جياب وفيدل كاسترو إلخ...
ثم إن القائد الفدائي الذي طالما أشارت إليه المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ووكالة المخابرات الأميركية (السي.آي.أي) كرئيس لمنظمة أيلول الأسود يكشف في مذكراته اسم الرئيس الحقيقي لهذه المنظمة ويورد سرداً تفصيلياً حول إعداد وتنفيذ عمليات الاغتيال الفلسطينية. وقد كان بعض هذه العمليات باهراً شأن عملية الألعاب الأوليمبية في ميونيخ، كما كان بعضها مجهولاً من الجمهور شأن اغتيال عملاء الموساد في أوروبا.
وأبو أياد يتمتع بمركز يتيح له أن يكشف النقاب عن "حرب الأشباح" التي ما تزال قائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات، فقد أصبح رئيساً لمخابرات منظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1970، بعد أن كان أحد أوائل المسؤولين عن دوائر فتح الأمنية (1968 – 1970).
ويكشف أبو أياد خفايا الحرب اللبنانية، وتفاصيل مقتل السفير الأميركي في بيروت، وتفاصيل اغتيال قادة المقاومة الثلاثة في بيروت: أبو يوسف وكمال عدوان وكمال ناصر...
وأخيراًيحدد الشروط التي يضعها الفلسطينيون لإقامة سلام مع الإسرائيليين: سلام ليس مبنياً على العدل – كما تدعو إليه جبهة الرفض – وإنما على العدل والواقعية معاً.
وفي ما يأتي ما لخصته "المستقبل" من مذكرات أبو أياد...
إنها ليست أكثر من أضواء ساطعة وسريعة تفضلت الزميلة الكويتية "الوطن" صاحبة الحق في نشر المذكرات وسمحت لنا بأن نقدمها إلى قراء "المستقبل"...
• سيظل يوم 13 أيار/ مايو 1948 محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد".
بهذه الجملة بدأ صلاح خلف (أبو أياد) مذكراته.. وذلك التاريخ هو اليوم الذي غادر فيه يافا مع عائلته بحراً باتجاه غزة، ولم يكن قد أكمل الخامسة عشرة من عمره.
وذكرياته ذلك اليوم يستعيدها بكل بشاعتها.. إذ "لم يكد المركب يرفع مراسيه حتى سمعنا عويل امرأة، فلقد لاحظت أن أحد أطفالها الأربعة لم يكن على متن المركب، وراحت تطلب العودة إلى المرفأ للبحث عنه، إلا أنه كان من الصعب علينا ونحن نتعرض لنيران المدافع اليهودية الغزيرة أن نعود أدراجنا فنعرض للخطر حياة ما بين مائتين وثلاثمائة شخص بينهم العديد من الأطفال المتراكمين في المركب. وذهبت توسلات تلك المرأة الباسلة سدى فانهارت باكية. وكنا بضعة أشخاص نحاول تهدئتها مؤكدين لها أنه سيتم إيواء ابنها الصغير بالتأكيد ثم يرسل في وقت لاحق إلى غزة، ولكن عبثاً إذ راح قنوطها يتزايد برغم أقوالنا وبرغم تطمينات زوجها، ثم إذ بأعصابها تنهار فجأة فتتخطى حاجز المركب وتلقي بنفسها في البحر. أما زوجها الذي لم يفلح في الإمساك بها فقد ألقى بنفسه إلى البحر أيضاً، ولم يكن أي منهما يحسن العوم فابتلعتهما الأمواج الهائجة أمام نواظرنا.. والمسافرون الذين أخذهم الروع كانوا كمن أصابه الشلل"!
وبعد أن يستعرض أبو أياد فظاعة الأحوال ووحشية الحرب يقول:
"لو قيل لي إبان سني حداثتي أن اليهود سيطردوننا ذات يوم من وطننا لكنت أول الناس استغراباً بل واستنكاراً، ذلك أنه كانت تصل أفراد عائلتي أفضل العلاقات باليهود، وكان لهم الكثير من الأصدقاء فيما بينهم، فجدي الشيخ عبد الله هو رجل دين من غزة ربى أطفاله بروح متسامحة، وتزوج أحد أبنائه من يهودية، كما لم يكن نادراً أن أسمع من يكبرونني سناً يذكرون اتصال حبل الغرام أو انقطاعه بين هذا أو ذاك من أقربائنا وبين فتاة يهودية"!
ويروي طفولته وكيف تعلم العبرية في محل والده وكيف اكتشف تدرب الماغاناه على استعمال السلاح وعن منظمة النجادة الفلسطينية التي انتمى إليها ليناضل دفاعاً عن الأرض، ثم يتحدث عن ظروف الحياة الصعبة التي عاشتها عائلته في غزة وما اجتازه من صعاب في سبيل تحصيل العلم، ثم الانطلاق في العمل النضالي ضمن اتحاد الطلبة الفلسطينيين..
وفي تلك الأيام كما يقول أبو أياد في مذكراته:
"التقيت للمرة الأولى بطالب يدرس في كلية الهندسة عمره 22 سنة ويكبرني بأربع سنوات ويتمتع بطاقة ونشاط وحماسة وروحية مغامرة أسرتني وجذبتني إليه: إنه ياسر عرفات، الذي عرفه العالم بعد ذلك بخمس عشرة سنة باسمه الحركي: أبو عمار، كان ياسر يومها مسؤولاً عن التدريب العسكري لطلاب الهندسة الراغبين في الاشتراك بالأعمال الفدائية ضد البريطانيين في منطقة قنال السويس، وبخلاف ذلك كان يناضل – شأني أنا – داخل اتحاد الطلاب الفلسطينيين الذي يضم زملاءنا الطلبة ممن ينتمون إلى كافة النزعات السياسية: الأخوان المسلمون، الشيوعيون، البعثيون، القوميون العرب إلخ.. إلا أنني – شأن ياسر عرفات – لم ألتحق بأي حزب سياسي. وكانت ميولي الطبيعية تحملني على أن أنضم إلى ركب قومية علمانية، ولم تكن لدينا أفكار مسبقة بهذا الصدد – ياسر عرفات ولا أنا – إلا أننا كنا نعلم على الأقل ما هو مضر بالقضية الفلسطينية".
بين تأميم القنال وثورة الجزائر:
ويقول أبو أياد أن المنعطف الحقيقي في حياته النضالية حدث في تموز/يوليو 1956 عندما أعلن جمال عبد الناصر تأميم شركة قنال السويس، ويروي عن لك الأيام فيقول:
"حين عبأنا أنفسنا للدفاع عن مصر ضد العدوان الذي شنته عليها إسرائيل وإنكلترا وفرنسا بعد تأميم القنال بثلاثة أشهر فإننا فعلنا ذلك بحماسة، وشكلنا كتيبة كوماندوس لنقاوم العدوان الثلاثي إلى جانب المتطوعين المصريين. أما ياسر عرفات الذي كان يومها ضابط احتياط فلقد أرسل إلى بورسعيد حيث أسهم ضمن سلاح الهندسة في عمليات نزع الألغام. وأما أنا فقد تطوعت من جهتي في المقاومة الشعبية، وكنت مستعداً للقتال ولكن السلطات لم تسمح لي بالذهاب إلى جبهة قنال السويس، ولذا كان علي الاكتفاء بأداء مهمات دفاعية كالقيام – في جملة ما قمت – بالحراسة أمام جسور القاهرة"!
ويذكر أبو أياد ما كانت تتناقله الأنباء عن بطولات الثوار الجزائريين ويقول:
"كنا نطرح على أنفسنا مسألة ما إذا لم يكن في وسعنا نحن كذلك أن ننشىء حركة واسعة تكون ضرباً من الجبهة التي تضم الفلسطينيين من جميع الاتجاهات، وينتمون إليها بصفة فردية بغية إشعال الكفاح المسلح في فلسطين. وفي سنتي 1954 – 1955 جرت بعض غارات الكوماندوس ضد إسرائيل إلا أنها كانت تقاد جميعها تقريباً من قبل استخبارات البلدان المجاورة لإسرائيل. وكنا نشعر أنفسنا معنيين قليلاً بالمشروعات التي لا تمليها المصلحة الفلسطينية. ولما كنا نرتاب في الأنظمة العربية فلقد كان تقديرنا بأن الكفاح المسلح الذي يستحق هذه التسمية هو كفاح ينبغي أن يعده وينظمه ويخوضه الفلسطينيون إلى غايته دون أن يكون لهم أي ارتباط بغير شعبهم".
ويحدد أبو أيا بعد ذلك الأسس التي وضعت لإنشاء كوادر حركة التحرير الفلسطينية، وكيف تفرق الرفاق حيناً ثم كيف اتفق الجميع على التسمية التي أطلقت على الحركة: فتح (حركة تحرير فلسطين) التي تصبح الأحرف الأولى منها ح.ت.ف. وإذا ما قلبت.. فتح، ثم كيف اكتملت مهمة تزويد الحركة بالبنى والأنظمة والقيادة المركزية في تشرين الأول/أكتوبر 1959.
هكذا قامت فتح.. وهكذا قمنا بأول عملية
ويروي أبو أياد تفاصيل وقوف حركة "فتح" على قدميها، وكيف عقدت الاجتماعات، وما جابهته من تحديات، وبخاصة من الجامعة العربية والأنظمة العربية وأحمد الشقيري، وكيف حرصت على استقلاليتها. ويذكر أبو أياد عن تلك الأيام:
إن النظام العربي الوحيد الذي أيدنا عام 1964 هو نظام بن بللا الذي سمح لنا بإقامة ممثلية في الجزائر، غير أن بن بللا الذي كان وثيق الصلة بعبد الناصر كان يرفض إعطاءنا أية معونة مادية، وإنما تسلمنا أول شحنة من السلاح من الجزائر عام 1965 بعد تسلم بومدين مقاليد السلطة. وعلى كل فلقد كان ذلك بفضل اللواء حافظ الأسد رئيس الجمهورية السورية الحالي الذي كان لنا معه علاقات طيبة منذ العام 1964. كان الأسد في تلك الأثناء قائد سلاح الطيران، وكان يستلم الأسلحة المرسلة إلينا بالطريق الجنوبي على سبيل الأمانة ثم يسلمها إلينا دون علم حكومته...
ويستعرض أبو أياد بعد ذلك كيف خطط لأول عملية فدائية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1964، وعن أول بيان نشرته الحركة في 28 كانون الثاني/يناير 1965 بتوقيع "العاصفة" وعن الملابسات التي رافقت انطلاق الكفاح المسلح في أكثر من عاصمة عربية، ويمضي قائلاً:
"بتنا قادرين على مواصلة وتطوير حرب العصابات، ومن العام 1965 حتى عشية حرب الأيام الستة قام فدائيون بحوالي مائتي غارة تقريباً. ولا ريب في أن معظمها جاء على نطاق متواضع بحيث أنه لم يكن يعرض أمن واستقرار الدولة الصهيونية للخطر، ولكن هذه العمليات أسهمت في زيادة التوتر بين إسرائيل والبلدان العربية التي كانت إسرائيل – ويا لسخرية القدر – تتهمها بتشجيع ودعم الحركة الفدائية. وفي الخامس من حزيران/يونيو 1967 علمت من الإذاعة أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً صاعقاً ضد مصر. وفي ذلك التاريخ انتهت مرحلة من حياتي كمناضل وأصبحت ثورياً متفرغاً. فالحرب التي بدأت يومذاك سجلت منعطفاً رئيسياً في تاريخ الحركة الفلسطينية".
ويتحدث أبو أياد في مذكراته بالتفصيل عن معركة الكرامة ويروي كيف أن أنباء الاستعداد لها وصلته من اللواء عامر خماش رئيس الأركان العامة في الجيش الأردني يوم 18 آذار/مارس 1968 وكيف أن اللواء أخبره بأن الهجوم الإسرائيلي سيقع خلال ثلاثة أيام، ثم يروي أبو أياد كيف قرر المسؤولون العسكريون في حركة فتح الصمود في وجه الهجوم المنتظر وطلبوا من أعضاء القيادة أن يغادروا المكان كإجراء أمني، إلا أن ياسر عرفات وفاروق القدومي وأبو صبري وأبو أياد قرروا الاشتراك في المعركة وتوزعوا في مختلف قطاعات الكرامة واستقر كل واحد في مغارة.
ويقدم أبو أياد تفاصيل معركة الكرامة فيقول:
"في 21 آذار/مارس – أي بعد ثلاثة أيام من تحذير اللواء خماش – أيقظني أحد الفدائيين عند الفجر ليعلمني ببدء الهجوم الإسرائيلي. كان في وسع المرء أن يميز أرتال مصفحات الجيش الصهيوني وهي تجتاز نهر الأردن تبعها تشكيلات من المشاة. وبدأت المدفعية بالقصف بينما راحت طائرات الهليكوبتر تلقي بالمظليين خلف خطوطنا. وهكذا راح حوالي 15 ألف رجل يندفعون في هجومهم على قواعدنا على جبهة تمتد ثمانين كيلومتراً تقريباً. إلا أنه كان بادياً أن الهجوم الرئيسي يتجه نحو الكرامة التي كان علينا أن ندافع عنها بأقل من 300 رجل. ودون أن ينتظر تعليمات القيادة العليا فإن اللواء مشهور حديثه أصدر أمره إلى المدفعية الأردنية بالرد، واستقبلت الدبابات الإسرائيلية في الكرامة بإطلاق نار غزير من قذائف الآر.بي.جي. وبوابل من القنابل اليدوية. ونزل الفدائيون من التلال ليخوضوا المعركة مجابهة وجسماً لجسم أحياناً وبالسلاح الأبيض. وأبدى البعض منهم بطولة انتحارية، فقد رأيت مثلاً أحد شبابنا من رجال الكومندوس وهو يدمر دبابة بأن ألقى بنفسه تحت جنزيرها وقد لف نفسه بحزام من المتفجرات.
أما أنا فلقد نجوت من الموت مرتين. كان أحد الفدائيين الذين أقودهم - ويدعى جورج – قد غادر المغارة التي أرابط فيها بحثاً عن ذخيرة. ولست أدري أي توجس غامض دفع بي إلى مغادرة المكان لأستقر وراء صخرة تقع فوق المغارة بما يقرب من المائة متر. وبعد ذلك بقليل شاهدت جورج يتقدم نحو المغارة رافعاً ذراعيه وتتبعه مجموعة من الجنود الإسرائيليين، ثم قذف هؤلاء بقنبلة مسيلة للدموع داخل مخبئي السابق قبل أن يفتحموه...
ولما كنت أعاني آلاماً في ظهري، فإنني لم أستطع اللحاق برجالي الذين تسلقوا التلال ليحتلوا مواقع أكثر أماناً. وحين بقيت وحيداً شاهدت مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين تتجه نحوي وأصابعهم على زنادات رشاشاتهم وهم يبحثون بصورة بادية عن مرمى، فبقيت جامداً دون حراك حتى اللحظة التي لم يعد يفصلهم فيها عن الصخرة التي أقبع خلفها سوى بضعة أمتار. وأخرجت مسدسي ببطء وهو جاهز للإطلاق. ولم يكن في مشطه سوى خمس رصاصات أدخر ذخيرتها لنفسي. إلا أن الجنود الإسرائيليين توجهوا بغتة وجهة أخرى مخلفينني وراءهم. وبعيد ذلك بقليل جاءت مجموعة فدائية تبحث عني وتساعدني على تسلق التلال لإيوائي في مكان أقل تعرضاً للخطر.
وتواصلت المعارك حتى المغيب، وبعدها شرعت القوات الإسرائيلية تلم موتاها وجرحاها كمقدمة للانسحاب. لقد دمروا ثلاثة أرباع مباني الكرامة، إلا أنهم كانوا راجعين في الحقيقة بخفي حنين".
المواجهة مع عبد الناصر:
وتمضي مذكرات أبو أياد في تفاصيل دقيقة ومؤثرة تروي الصعاب والخلافات والتحديات التي كانت تواجه المقاومة الفلسطينية.. ويصل بعد ذلك إلى المواجهة التي تمت مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد قبوله مشروع روجرز وعن الزيارة التي قام بها وفد المقاومة الذي ضم عرفات وفاروق القدومي وهايل عبد الحميد وأبو أياد فقال:
"استقبلنا عبد الناصر ببعض الفتور ثم قال لنا: لقد تنزهت في حديقتي طول ساعة لأتمالك غضبي وأنا أستقبلكم". كان غاضباً من الهجمات التي تعرض لها في منشورات فتح والتي عرض لنا نماذج منها كانت مبعثرة على مكتبه. ثم أضاف إنه لا يحق لنا أن ننتقده قبل أن نعرف البواعث التي دفعته إلى قبول مشروع روجرز، وأشار خلال المحادثة التي دامت أكثر من سبع ساعات إلى أن هناك إمكانية بنسبة واحد بالألف في أن يتحقق مشروع السلام الأميركي لأنه يعلم مقدماً أنه ليست لدى إسرائيل النية مطلقاً في احترام التزاماتها وإعادة الأراضي المحتلة بكاملها. ولكنه سيواصل برغم ذلك جهوده للتوصل إلى تسوية سلمية. وبانتظار ذلك لا بد له من كسب الوقت ليستعد للحرب التي تبدو له للوهلة الأولى أمراً لا مناص منه. وأضاف أنه خلال زيارته الأخيرة لموسكو طالب بتسليم مصر صواريخ سام 7 وحصل عليها بعد أن هدد بالاستقالة، ثم أفضى لنا بأنه سيستغل وقف إطلاق النار الساري لتركيز هذه الصواريخ على طول قنال السويس. وروى لنا أن القادة السوفيات اندهشوا في بادىء الأمر من انضوائه تحت راية مشروع أميركي وعرضوا عليه كبديل مشروعاً تقدمه له موسكو وواشنطن معاً فرفض المشروع موضحاً لمحادثيه بأنه يريد أن "يحرج" الولايات المتحدة التي التزمت لأول مرة منذ حرب حزيران/يونيو 1967 بجلاء إسرائيل الكامل تقريباً عن الأراضي التي غنمتها وأضاف: إن ميزة القرار 242 هو أنه صدق على حق العرب في استعادة أراضيهم المفقودة بإقرار دولي.
ثم استطرد عبد الناصر يقول بلهجة ساخرة وهو يلتفت نحو ياسر عرفات:
"كم تظن أنه يلزمكم من السنين حتى تدمروا الدولة الصهيونية وتبنوا دولة موحدة ديمقراطية على كامل فلسطين المحررة؟". وأخذ علينا ممارستنا لسياسة غير واقعية وقال: إن دويلة في الضفة الغربية وغزة خير من لا شيء".
وينتقل أبو أياد بعد ذلك ليتحدث بالتفصيل عن أحداث أيلول/سبتمبر وعن آخر مؤتمر قمة حضره عبد الناصر. وعن الصدمة التي شعروا بها جميعاً عندما بلغهم نبأ وفاته وقال:
"كان عبد الناصر أباً لنا جميعاً وهادياً حتى ولو كان يحدث له أن يخطىء. وقد أدى كوطني خدمات جلى للشعب المصري وقدم كقومي عربي معونة لا تقدر للشعب الفلسطيني، ذلك أنه كان يحبنا حباً صادقاً، وظل وفياً للالتزامات التي قطعها لنا منذ لقائنا الرسمي الأول العام 1968. وكان كثيراً ما يستقبلنا دون أن يحسب حساب الوقت الذي يولينا إياه. وكانت محادثاتنا تتصف بالصراحة وتنتهي دائماً بنتائج ملموسة. ولا زلت أذكر محادثة أجريناها معه – عرفات وأنا – في تشرين الثاني/نوفمبر 1969 بحضور أنور السادات، فقد حرص على أن يوصلنا إلى درج مدخل منزله ثم راح يتتبعنا بعينيه ونحن نتجه نحو سيارتنا. ورأيت نظرته. كانت نظرة مشرقة مليئة بالحنو الأبوي وبالرضا. وهمس السادات الذي كان يسير إلى جانبنا يقول: "إن الريس يحبكما كثيراً أنتما الإثنين، وهو يسعد كثيراً عندما يراكما متحدين في الكفاح فأيداه بلا قصور فإنه يحتاج إلى ذلك".
ويستعرض أبو أياد بعد ذلك كل الظروف التي عاشتها المقاومة والتي زادت في جراحها، والتي أوصلتها كذلك إلى تحويل الغضب الذي جاش في النفوس وتوجيهه وإعطائه بنية ذات محتوى سياسي. وكان ذلك بداية وجود "منظمة أيلول الأسود".
أيلول الأسود: رئيسها ونشاطها
ويشدد أبو أياد في حديثه عن منظمة أيلول الأسود على عدم وجود علاقة بين فتح والمنظمة من جهة، وأنه خلافاً لكل ما يقال ويشاع ليس رئيسها.. فرئيس المنظمة مناضل معروف باسم "أبو إيهاب"!
ويحدد أبو أياد موقفه من الاغتيال السياسي فيقول:
"إذا كنت بحكم طبيعتي وأيديولوجيتي عدواً لدوداً للاغتيال السياسي، ثم للإرهاب عامة، إلا أنني لا أخلط كما يفعل كثيرون في أرجاء العالم، بين العنف الثوري وبين الإرهاب، وبين ما يشكل فعلاً سياسياً وبين ما ليس كذلك. وأرفض الفعل الفردي الذي يرتكب خارج أي تنظيم أو أية استراتيجية، أو تمليه بواعث ذاتية، ويدعي الحلول محل كفاح الجماهير لشعبية. وعلى العكس من ذلك، فإن العنف الثوري ينخرط في حركة واسعة ذات بنى يشكل قوة متممة لها، ويسهم في مدها في فترات الجزر أو الهزيمة بانطلاقة جديدة. لكنه يصبح نافلاً لا جدوى منه عندما تسجل الحركة الشعبية نجاحات سياسية، على الصعيد المحلي أو على المسرح الدولي.
و"أيلول الأسود" لم تكن منظمة إرهابية مطلقاً. بل تصرفت دائماً كرديف ملحق بالمقاومة في الحين الذي لم يكن بوسع هذه الأخيرة فيه ان تضطلع بمهماتها العسكرية والسياسية كاملة. وقد أكد أعضاؤها دائماً وأبداً أنه ليست لهم أية صلة عضوية بفتح أو بمنظمة التحرير الفلسطينية. قد عرفت عدداً منهم، وأستطيع أن أؤكد أنهم ينتمون في غالبيتهم إلى مختلف المنظمات الفدائية. وبالنظر إلى أنهم خرجوا من صفوف هذه المنظمات، فإنهم كانوا يترجمون ترجمة صادقة مشاعر الإحباط والسخط التي تعتمر الشعب الفلسطيني".
ويروي أبو أياد في مذكراته تفاصيل هامة ومثيرة عن عدد كبير من الأعمال التي خططتها ونفذتها منظمة "أيلول الأسود"، ويصف حرب المنظمة ضد الاستخبارات الإسرائيلية بأنها كانت "حرب أشباح"، ويقول:
"إن الظروف التي يعيشها المعتقلون من أفراد المقاومة في سجون إسرائيل تفرض العمل على إطلاق سراح قسم منهم، كما أنه تم بذل كل ما يمكن بذله في هذا السبيل لكن دون طائل، فمحاولات الهرب المنظمة أجهضت الواحدة بعد الأخرى، والمداخلات الدولية المختلفة الأنواع، لم تفض إلى أية نتيجة. وواجهت إسرائيل النداءات والمساعي المتكتمة التي قامت بها الهيئات الإنسانية كالصليب الأحمر، والدول العظمى والصغرى وهيئة الأمم المتحدة والبابا ومختلف المؤسسات الدينية، بجدار من اللامبالاة وعدم التحسس. ومن هنا كان اللجوء إلى القوة وإلى خطف الطائرات من قبل بعض الفصائل الفلسطينية.
إلا أنه تبين أن سلاح اليأس النهائي هذا، غير فعال هو الآخر. فباستثناء أول عملية اختطاف طائرة عام 1969،أي تلك العملية التي أخذت إسرائيل على حين غرة، فإن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا رفضاً قاطعاً إجراء أية تسوية مع الخاطفين. بل ثمة ما هو أسوأ من ذلك، إذ كانوا يبذلون قصارى جهدهم، لدى كل مواجهة، للإفضاء إلى نهاية دموية بهدف تأليب الرأي العام العالمي ضد الفدائيين. وهكذا فإنه سريعاً ما ظهر لنا أن خطف الطائرات لا يخدم قضيتنا، بل يضر إضراراً فادحاً بمعنى معركتنا التحريرية نفسه.
ولهذا السبب ذاته، أدانت فتح بلا هوادة مختلف العمليات الأخرى مثل تلك المغامرة الخرقاء التي قام بها أولئك الذين احتلوا في أيلول/سبتمبر 1973، سفارة المملكة العربية السعودية في باريس ليأخذوا بعض الدبلوماسيين كرهائن، أو العملية – التي تفوق هذه شبهة – والتي قام بها المغامر كارلوس في كانون أول/ديسمبر 1975، حين هاجم مقر منظمة الدول المصدرة للنفط – أوبيك في فيينا، لحساب ما يرجح أن يكون قوى خفية تعمل على المسرح الدولي للنفط. ولطالما تردد بهذا الصدد اسم العقيد القذافي الذي حاكت الصحافة الدولية حوله أسطورة أظهرته فيها (كسوبر – إرهابي) أو ما فوق إرهابي. إلا أنني أستطيع أن أؤكد من جهتي وبناء لمعرفتي بالوقائع، بأن الرئيس الليبي ظل بعيداً عن كامل العمليات العنيفة التي نظمت في السنوات الأخيرة تقريباً.
أسرار عملية ميونيخ بالتفصيل
وبالمقابل، فإن فتح لم تندد بالعملية التي قامت بها "أيلول الأسود" في ألعاب ميونيخ الأولمبية في أيلول/سبتمبر 1973. وقد يدهش المرء لهذا الموقف إذا لم يعرف بواعث وأهداف وسلوك القائمين بها، والأحداث التي أفضت إلى الخاتمة الدموية التي انتهت إليها. وبما أنني أعرف جيد المعرفة جميع مسؤولي مجموعتي المغاوير الذين قاموا بالعملية، مصالحه وشي غيفارا – وفقاً لاسميهما القتاليين – وبما أنني استجوبت مطولاً الناجين الثلاثة من المجموعة والذين يعيشون حالياً في بيروت، فإنني أجدني في وضع يتيح لي أن أقدم سرداً بالقدر الذي تسمح به القواعد الأمنية من التفصيل.
في مطلع العام 1973، وجهت منظمة التحرير الفلسطينية رسالة رسمية إلى اللجنة التي تدير الألعاب الأولمبية مقترحة اشتراك فريق من الرياضيين الفلسطينيين بالألعاب، وبما أن العرض ظل بلا جواب، فإن المنظمة أرسلت رسالة ثانية، لم تلق هي الأخرى غير الصمت التحقيري. فكان من البديهي، أننا غير موجودين بالنسبة لهذه المؤسسة المحترمة التي تدعي أنها غير ذات طابع سياسي، أو أننا – وذلك احتمال أفدح سواء من الاحتمال الأول – لا نستحق الوجود.
وقد أثارت هذه الإهانة سخط وغضب مقاتلينا الشباب. فقررت قيادة "أيلول الأسود" أن تأخذ هذه القضية بيديها، وأن تضع مشروعاً يستهدف ثلاثة أمور: تأكيد وجود الشعب الفلسطيني إزاء الكافة وضدهم. الإفادة من الانتشار الخارق للوسائل الإعلامية في ميونيخ لتعطي قضيتنا دوياً عالمياً، بالمعنى الإيجابي أو السلبي ما هم! وأخيراً التوصل إلى إطلاق إسرائيل سراح مقاومين، حدد عددهم الأولي بمائتين.
وينبغي لي أن أقول إننا لاحظنا، ويا لعظم كآبتنا حينها، أن قسماً هاماً من الرأي العام العالمي تأثر لتوقف العرض المسرحي، الذي تمثله الألعاب الأولمبية بالنسبة إليه لمدة أربع وعشرين ساعة، بأكثر مما تأثر للمصير المأساوي الذي عاناه الشعب الفلسطيني طوال أربع وعشرين سنة.
وقد جرى الإعداد للعملية بجدية ودقة مثاليتين. والمسؤولان اللذان جرى اختيارهما قبل العملية بثمانية أشهر، هما من المناضلين المجربين.
كان عمر مصالحة سبعة وعشرين سنة، وكان قد غادر مسقط رأسه حيفا وهو طفل بصحبة ذويه، وهم من الفلاحين الفقراء، إلى الضفة الغربية. كما كان يحمل درجة التبريز في الجيولوجيا ويتمتع بشخصية مؤثرة بالنظر إلى قامته المهيبة وذكائه الوقاد، واختار الالتحاق بصفوف منظمة فتح حيث عهد إليه بوظيفة مفوض سياسي. وبالنظر إلى إجادته فوق هذا كله، للغة الألمانية، فإنه كان في وضع يؤهله لتولي قيادة المجموعة، شأنه في ذلك شأن صديقه وشريكه شي غيفارا، المتمرس بالأساليب الفدائية برغم حداثة سنه (25 سنة) وبرغم دراسته الحقوقية في باريس.
ووفقاً للأهداف السياسية الثلاثة المعينة للمحاولة فإنه أوكل إليهما القيام بأربع مهمات واضحة: رسم خطة تفصيلية لسير العملية، اختيار ستة فدائيين آخرين يشتركون معهم في المحاولة، الحصول على الأسلحة الضرورية وإيصالها إلى داخل القرية الأولمبية، وأخيراً الاضطلاع بتنفيذ الخطة، بما في ذلك المساومات التي ستدور لمبادلة الرهائن الإسرائيليين بالمساجين الفلسطينيين. وبطبيعة الحال، فإن مصالحه وشي كانا يتمتعان بحشد من المعاونين والمنفذين لإيصال مشروعهم إلى غايته.
ولم يكن اختيار أفراد المجموعة بالأمر اليسير. ففي الفترة الأولى، جرى اختيار خمسين فدائياً شاباً ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة ليتلقوا تدريباً مكثفاً. وكانوا يتحدرون جميعاً من مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن وينتمون في معظمهم إلى عائلات متواضعة ويحدوهم جميعاً حافز إرادة تحرير أفراد عائلاتهم المسجونين في السجون الإسرائيلية. وكانوا يجهلون كل شيء عن المهمة التي ربما أوكلت إليهم، إلا أنهم كانوا يتحرقون لكي يكونوا بين المختارين المحظوظين. وقد أثار الاختيار النهائي بعض المآسي. فقد استبعد أحد الفدائيين اليافعين لأنه سبق لاثنين من أشقائه أن سقطوا في ساحة الشرف. فسخط الشاب الصغير واحتج وتضرع وانفجر باكياً. ثم راح يهدد بالانتحار إذا لم يضم إلى مجموعة المغاوير. فانتهى الأمر بالمسؤولين إلى الإذعان وضموه إلى المجموعة. فكان أحد أوائل من سقطوا برصاص قوات الأمن الألمانية...
وقبل أن ينتشر المصطفون الستة في مختلف البلدان الأوروبية، حيث ينبغي لهم أن يعتادوا نمط الحياة الغربية، فإن مصالحه وشي ذهبا إلى ميونيخ على سبيل الاستشاف. وتمكن أولهما، بعد أن غير ملامحه بأن اصطنع، بين جملة ما اصطنعه، شعراً مستعاراً، من أن يجد عملاً كخادم مقصف في القرية الأولمبية حيث كانت الاستعدادات للحدث الرياضي تجري على قدم وساق. واستغل هذا الوضع ليقوم بتفتيش الأمكنة وتحريها بانتظام وذلك لجهة ترتيب الأجنحة وخاصة الجناح الإسرائيلي، والمخارج الممكنة. ثم راح يستفيد من جملة صلات الصداقة التي أقامها مع عدد من المستخدمين الألمان وسواهم وكذلك مع شابة آسيوية شغفت به، ليجمع كمية من المعلومات راح يبلغها شيئاً فشيئاً إلى شي الذي استقر في بلد أوروبي مجاور. وهكذا فإن هذه العملية التي استغرقت أربعة أشهر، أفضت إلى مخطط عمل واضح ومتماسك.
الأسلحة تهرب في حقائب عروسين!
إلا أن عقبة طرأت في اللحظة الأخيرة، طرحت مشكلة جدية على المنظمين. ففي الموعد المضروب لتسليم الأسلحة إلى المغاوير، بلغهم أن الرقابة البوليسية تعززت فجأة في ألمانيا على المراكز الحدودية والطرق والمحطات وخاصة في المطارات وذلك في حين كانت المهلة المتبقية أقصر من أن تتيح استخدام وسيلة نقل أخرى غير الطائرة...
فقرر المنظمون أن يلعبوا رهانهم كاملاً. وكدست الأسلحة المودعة في أحد البلدان العربية دون علم حكومته، في ثلاث حقائب وعهد بها إلى منالة وإلى أحد أعاء "أيلول الأسود" بعد أن عقد "قرانهما" لهذه المناسبة بواسطة جوازات سفر مزورة. وسافر "الزوجان" إلى بون مصحوبين بحقيبتين إضافيتين تحتويان أمتعتهما الشخصية. ولدى خروجهما من المطار طلب إليهما موظف الجمارك وكان محاطاً برجال أمن، أن يفتحا حقائبهما. غير أن الرجل عاند وأبى، معلناً أنه يشعر بالإهانة إزاء هذه المعاملة. فهو رجل أعمال وسائح كبير، كما زعم، ولم يحدث له أن عومل كشقي أو أهين بهذه الطريقة. وباختصار، فإنه تذرع بحجج غير مقنعة تنحصر قيمتها الوحيدة في كسب الوقت، في وضع كان يبدو يائساً بصورة ظاهرة.وأصر موظف الجمارك على أنه لا يستطيع ان يخرق قانوناً يطبق على كافة المسافرين. أما ممثل "أيلول الأسود" فإنه راح يتردد أمام سبيلين ممكنين. فإذا استمر في رفضه فتح حقائبه فإنه سيضطر للرحيل في أول طائرة تغادر بون وفي هذه الحال ستلغى عملية ميونيخ. ولهذا فإنه اختار البديل الثاني وطلب باستكانة إلى موظف الجمارك أن يعين له الحقيبة التي يريد تفتيشها من بين الحقائب الخمسة التي كانت كلها متشابهة. وفتح الحقيبة المعينة له ثم نشر... الملابس الداخلية النسائية التي كانت فيها. فارتبك الجمركي وراح يغالي في الاعتذار مرحباً بهما في ألمانيا الاتحادية...
ووصلت الأسلحة إلى مقصدها قرابة الخامس والعشرين من شهر آب/أغسطس، أي قبيل بدء الألعاب الأولمبية بعشرة أيام تقريباً. وفي بون، استبدلت حقائب "الزوجين" بحقائب مماثلة، ولكن خاوية، وتولاها مناضلون آخرون فقاموا بوضع الأسلحة – وهي عبارة عن رشاشات وقنابل يدوية وسواها – في صناديق ودائع الأمانات في محطة ميونيخ حيث أتى بعد ذلك أفراد مجموعة المغاوير لطلبها كل بمفرده وبمفتاحه الخاص في ساعات مختلفة، قبيل دخولهم إلى الحرم الأولمبي.
وسبقهما مصالحه وشي ودخلا من البوابة الكبرى بفضل بطاقتي الدخول اللتين نجحت صديقة أولهما بالحصول عليها. أما رفاقهما الستة فكان عليهما أن يتسلقوا السياج المحيط بالقرية الأولمبية والذي يبلغ علوه مترين. وضرب لهم موعد مع الرجل الذي سوف يقودهم إلى هناك ويسخدمونه كمرتكز أو كمرقاة عند طرف السياج. وقبيل وصولهم كانت إحدى المناضلات التي لا يعوزها الجمال، قد ذهبت إلى المكان لتدخل في محادثة مع موظف الأمن الألماني الذي يقوم بالحراسة. وإذ تمكنت بذلك من إلهائه، فإن أفراد المغاوير نجحوا في القفز عن السياج دون أن يعيقهم أي عائق. وبعيد ذلك بساعات، كانت الفتاة والدليل قد غادرا ألمانيا بالطائرة.
رهائن.. ومفاوضات.. وتآمر في الخارج!
كان الجناح الذي يقيم فيه الرياضيون الإسرائيليون يبعد مسافة خمسين متراً عن السياج. وقد اصطدمت المجموعة – التي كانت تلقت تعليمات دقيقة بعدم إحداث ما يريق الدم إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس – بمقاومة عنيفة من قبل اثنين من مدربي الفريق الرياضي، فنشب إثر ذلك عراك انتهى بقتلهما. أما الرياضيون التسعة الذين أخذوا كرهائن فقد عوملوا معاملة حسنة، بل أكثر من حسنة وأبلغهم مصالحه وشي خاصة بأنهم سيبادلون بمعتقلين فلسطينيين.
وخلال مدة الإحدى وعشرين ساعة لمحاصرة المبنى على يد البوليس الألماني، دارت بين الفدائيين ورهائنهم مناقشات ودية طويلة. كانت أعمار هؤلاء الآخرين تتراوح بين 18 و30 سنة وكانوا في معظمهم مهاجرين جدداً وفدوا إلى إسرائيل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ورومانيا وبولونيا وغيرها، وينتمي كثيرون منهم إلى أطر وكوادر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. وقد أوضح لهم الفدائيون أن مكان فلسطين في الألعاب الأولمبية قد أسند ظلماً إلى إسرائيل، التي كان ينبغي على كل حال أن تطرد من هذا التجمع العالمي شأنها شأن جنوب إفريقيا وروديسيا.
وقد أكد مصالحه – الذي تزوج أحد أقاربه الأقربين من يهودية – للرياضيين، بأن الفلسطينيين لا يكنون أية كراهية لليهود أو حتى للإسرائيليين الذين هم شأن الفلسطينيين وإن بصورة مختلفة عنهم، ضحايا المغامرة الصهيونية. وبالرغم من أن الرهائن كانوا مهتمين بالحوار، إلا أنهم أصروا على أن السياسة ليست مركز اهتمامهم.
وظهر أن المفاوضات مع المسؤولين الألمان – الذين عملوا كوسطاء بين الفدائيين وإسرائيل – هي بالصعوبة التي كانت متوقعة. وكان عناد السيدة غولدا مائير رئيسة الحكومة الإسرائيلية في تلك الأثناء غير طبيعي تماماً، إذ أنها لم تظهر أي رغبة في إنقاذ حياة الرهائن. أما المغاوير الذين كانت التعليمات الصادرة إليهم توصيهم بألا يقتلوا أسراهم، فإنهم راحوا يمددون فترة الإنذار ساعة بعد أخرى، على أمل أن تقدم لهم صيغة تسوية ما. كانوا يعلمون مقدماً أنه لا يمكنهم الحصول على إطلاق سراح المئتي معتقل الذي أعدت لائحة بأسمائهم وفقاً لعددهم ونزعاتهم السياسية، وتوزعهم على العشرة آلاف سجين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. إلا أنهم كانوا مستعدين عملياً لمباللة رهائنهم التسعة بخمسين أو عشرين أو حتى بتسعة معتقلين فلسطينيين. غير أن أملهم خاب ولم يقدم لهم المفاوضون الألمان والإسرائيليون أي عرض مضاد، اللهم إلا تقديم مبلغ غير محدد من المال أو "شيك على بياض" – كما لو كانوا مجرد أشقياء – وذلك مقابل إطلاق سراح الرهائن وتقديم جوازات مرور للثوريين الستة.
وفي اللحظة التي وصلت فيها المساومات إلى مأزق خطير، قامت سفارة عربية بإيصال اقتراح إلى مصالحه يمكن أن يكون موضوع اتفاق سري: وقوام الاقتراح هو أن يجري إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين واستبدالهم بمتطوعين ألمان يقتادهم الفدائيون إلى أحد البلدان العربية. وبعد ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر تقوم إسرائيل بإطلاق سراح خمسين سجيناً سراً بعد أن تتولى عدة دول عظمى ضمان احترام هذا الاتفاق.
أزمة دبلوماسية بسبب تشابه الأسماء
ومهما يكن من أمر، فإن هذا الطارىء المأساوي – الهزلي أفضى إلى أزمة ديبلوماسية. فقد حمل سفير ألمانيا الغربية في تونس تسجيل المحادثات الهاتفية بيديه وتقدم باحتجاج حاد إلى الحكومة التونسية مطالباً بتسليم مسؤولي "أيلول الأسود" الموجودين في تونس. وبعد عمليات أخذ ورد طويلة، تم الاتفاق على عدم إشاعة القضية. ومع هذا فإن السفير شبيلات وسائر أفراد عائلته طردوا من تونس بعد أن كانوا يتمتعون بحق اللجوء فيها.
أما مصالحه، فإنه أدى مهمته بأن احتمى بموقف الانكفاء الوارد في المخطط الذي كلف بتنفيذه. ذلك أنه، إزاء تصلب الإسرائيليين اقترح، كحل نهائي، أن يسافر الفدائيون ورهائنهم إلى القاهرة. وإنما وضع هذا الحل البديل، كمحاولة إضافية لتلافي إعدام الرهائن دون الإضرار بمصداقية "أيلول الأسود". فمصر ما كانت ستسمح مطلقاً بأن تمرغ سيادتها على أرضها. وعلى هذا فإن الرهائن الإسرائيليين كانوا سيحتجزون بصفتهم رعايا لبلد عدو، فلا يطلق سراحهم إلا إذا قبلت السلطات الإسرائيلية بالمبادلة. أو بعبارة أخرى، فإن مصيرهم لم يكن سيختلف، في أسوأ الافتراضات، عن مصير المقاومين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الدولة اليهودية.
غير أن المستشار ويللي براندت كان يطمع بالحصول على المزيد، فقد اتصل هاتفياً برئيس الحكومة المصرية عزيز صدقي وأبلغه آخر اقتراحات مصالحه، طالباً إليه العمل بحيث يجري إطلاق سراح الرياضيين الإسرائيليين وطردهم لدى وصولهم إلى القاهرة بصحبة الفدائيين، بعد أن تقوم السلطات المصرية بتحييد هؤلاء اآخرين. وبطبيعة الحال، فإن عزيز صدقي الذي أبلغني المحادثة كلمة كلمة، رفض اقتراح المستشار موضحاً أنه لا يليق بشرف حكومته أن تخون ثقة الفدائيين على هذا النحو.
ولست أدري ما إذا كان المستشار براندت عارفاً أم لا، بأن السلطات الألمانية كانت تتآمر، إبان هذه المحادثة وبتعاون وثيق مع المخابرات الإسرائيلية، من أجل اغتيال الفدائيين. وقد جرى إعداد عدة مشاريع قبل أن يقر القرار على أن ينصب الكمين للفدائيين في مطار فيوزشتنفيلد بروك العسكري، حيث كان يفترض أن يطير المغاوير والرهائن من هناك على متن طائرة لوفتهانزا باتجاه القاهرة.
زحف الفدائيان وهما صريعان ليتصافحا
أما الخاتمة المفجعة التي أفضت إليها هذه الحكاية نتيجة لازدواجية الحكومة الألمانية المشؤومة، فمعروفة. فقد انتهكت هذه الأخيرة الاتفاق المعقود والعهد المعطى وأمرت نخبة قناصتها بفتح النار على أفراد الكوماندوس. كان مصالحه وشي قد هبطا لتوهما من طائرة اللوفتهانزا بعد أن فتشاها ليتوجها نحو طائرات الهليكوبتر التي تضم الرهائن المنتظرين فيها، فكانا أول المصابين. وقد ردا على النار بشجاعة قبل أن يسقطا في بركة من الدم ثم زحفا وهما في طور الاحتضار نحو بعضيهما وتصافحا مصافحة أخوية قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة. ثم أن مقاتلاً ثالثاً كان يقوم بالحراسة سقط قتيلاً هو الآخر. ولم يشاهد انفجار طائرتي الهيلوكوبتر إلا بعد موت أفراد المجموعة الرئيسيين الثلاثة وبعد انتهاء تبادل إطلاق النار. وعلى هذا، فإن الفدائيين اللذين كانا يرافقان الرياضيين الإسرائيليين – واحد في كل طائرة – لم يعمدا إلى قتل رهائنهما والانتحار معهم، إلا بعد أن لاحظوا أنه لم يبق لديهما ما يأملانه. أما الأعضاء الثلاثة الباقون، فإنهم جرحوا فسلموا أنفسهم.
وبالإجمال، فإن تضحيات أبطال ميونيخ لم تذهب هدراً. فإذا كانوا لم يتوصلوا كما كانوا يأملون إلى تحرير رفاقهم السجناء في إسرائيل، إلا أنهم بلغوا الهدفين الآخرين المرسومين للعملية: فقد اطلع الرأي العام العالمي على المأساة الفلسطينية بفضل دوي الألعاب الأولمبية. كما فرض الشعب الفلسطيني حضوره على هذا التجمع الدولي الذي كان يسعى لاستبعاده. أما الخاتمة – المجزرة، فتتحمل حكومتا جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة إسرائيل خاصة، المسؤولية الراسخة الجسيمة فيها.
ثم إن السلطات الألمانية راحت تسعى مدفوعة بشعور بالذنب أو ربما بدافع من الجبن، إلى التخلص من الفدائيين الأسرى. وجاءتها الفرصة بعد ذلك بشهرين في 29 تشرين الأول/ اكتوبر 1972 عندما قامت مجموعة مغاوير فلسطينية باختطاف طائرة بوينغ تابعة لشركة لوفتهانزا تعمل على خط بيروت – فرانكفورت إلى زغرب. وطالبت بالإفراج عن الناجين من عملية ميونيخ، فأفرج عنهم فوراً ليعودوا جنوداً مجهولين.
وتواصل "حرب الظلمات" أو حرب الأشباح كما يسميها البعض وهي تزداد كما وكثافة. ووجهت مخابرات الدولة الصهيونية بطرود ملغومة إلى جمهرة مناضلينا في عدد من العواصم والحاضرات بينها بيروت والجزائر (حيث أصيب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية أبو خليل بجراح جسيمة) وطرابلس (حيث أصيب مصطفى عوض زيد ممثل منظمة التحرير بالشلل والعمى) والقاهرة (حيث أرسل طردان إلى اثنين من قادة فتح، فاروق القدومي وهايل عبد الحميد، أفلتا منهما سالمين) وستوكهولم (حيث فقد عمر صوفان مدير الصليب الأحمر أصابع يديه) وبون (حيث أصيب عدنان أحمد من اتحاد الطلاب الفلسطينيين بجراح جسيمة) وكوبنهاغن (حيث فقد الطالب أحمد عبد الله ذراعه). وبعد مقتل ممثلي منظمة التحرير في روما وباريس – زعيتر والهمشري – جاء دور ممثل المنظمة في نيقوسيا حسين أبو الخير حيث اغتيل في 25 كانون الثاني يناير 1973.
وقد ردت "أيلول الأسود" بقدر ما في وسعها، مضاعفة من عملياتها. فبعد مقتل أبو الخير بثلاثة أيام، قامت بقتل عميل إسرائيلي في قلب مدريد كان يتسمى باسم باروخ كوهن في حين أن اسمه الحقيقي هو مويس هنان ايشي. ولما كان حائزاً عدة جوازات سفر فإنه غالباً ما كان يتنقل تحت هويات مختلفة بين عاصمة أوروبية وأخرى وخاصة بين باريس وبروكسل وروما. وكان من البديهي أن كوهن يشغل وظائف هامة داخل مخابرات الدولة اليهودية. فقد شكل، بين جملة ما شكله، شبكة من الطلاب الفلسطينيين في إسبانيا، كان أفرادها في معظمهم من مواليد الضفة الغربية وغزة، مسنداً إليهم مهمات الإثارة والاستفزاز والتجسس. وكانت إحدى مهماتهم الاستعلام عن الفلسطينيين المقيمين في إسبانيا وخاصة لجهة ميولهم وانتماءاتهم السياسية. وكانت إحدى مهامهم الأخرى هي جمع المعلومات والاستخبارات في البلدان العربية – كمصر ولبنان مثلاً – البلدين اللذين كان بعض هؤلاء المجيشين يزورونهما أثناء العطل المدرسية. وفي مرحلة لاحقة، أنشأ كوهن خططاً لمهاجمة مؤسسات إسبانية يملكها يهود أو أن لها علاقات تجارية وثيقة مع إسرائيل وذلك بهدف الحط من اعتبار الفلسطينيين في نظر الرأي العام، والتسبب في طردهم من أسبانيا.
غير أنه كان يجهل أن العديد من هؤلاء المجيشين، أعضاء في "أيلول الأسود" وأنهم يتظاهرون بالتعاون معه بناء لطلب هذه المنظمة. وأنه تقرر إعدامه عندما بدأ يشك جدياً بأمانة ووفاء هؤلاء الذين لم يكونوا يقومون بتنفيذ المهمات التي أوكلها إليهم، متذرعين بذرائع مختلفة. وبات إعدامه أمراً ملحاً عندما أعلن بعيد مصرع محمود الهمشري في باريس، بأنه نقل إلى وظائف أخرى. فقد كان كوهن وفقاً لمعلومات "أيلول الأسود" أحد مدبري اغتيال ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا.
ثم إن كوهن نفسه حدد موعد إعدامه عندما أبلغ "صلته" الفلسطيني في مدريد بأنه سيلاقيه في 28 كانون الثاني يناير في مدريد للمرة الأخيرة. وذهب الطالب وفق ما هو متفق عليه إلى مقصف (بار) يقع في أحد شرايين العاصمة الرئيسية. والواقع أن ثلاثة من أفراد "أيلول الأسود" كانوا على الموعد. فبخلاف محادث العميل الإسرائيلي كان هناك رجلان مسلحان، أحدهما داخل المقصف والآخر خارجه ينتظران اللحظة المؤاتية للشروع بالعمل.
وبعيد وصوله إلى المقصف، أبلغ كوهن الطالب بأنه سيقدمه إلى خليفته ودعاه إلى أن يتبعه. فكان ذلك نعمة غير مأمولة. لكن الطالب الذي كان يتمنى إرجاء الإعدام لكي يتمكن من معرفة العميل الإسرائيلي الجديد، لم يجد أية وسيلة لتحذير شريكيه. وقد قلق هذان الآخران عندما شاهدا كوهن وصاحبه يغادران المقصف فجأة. فهذا الانتقال غير متوقع، بحيث أن الرجل المستهدف قد يفلت منهم ويختفي فجأة في زحام المشاة كعادته. وفتح أحدهم النار عن كثب فأردى كوهن قتيلاً، بينما أطلق الآخر النار في الهواء إرهاباً، بحيث تمكن المغاوير الثلاثة من الضياع في الزحام قبل أن يغادروا الأراضي الإسبانية بالطائرة.
وهكذا فإن "أيلول الأسود" رمت برمية واحدة فأصابت المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إصابتين. ذلك أن إعدام كوهن أدى إلى تصفية مجمل الشبكة الإسرائيلية في أسبانيا. ذلك أن إعدام كوهن أدى إلى تصفية مجمل الشبكة الإسرائيلية في إسبانيا. إذ لما كانت المخابرات الإسرائيلية تجهل أي "مجنديها" الفلسطينيين هو قاتل عميلها، فإنها اضطرت، من قبيل الحكمة والاحتراس إلى قطع علاقاتها بكافة أعضاء المنظمة التي كونها كوهن بصبر وأناة.
وفي هذه الاندفاعة، قتلت "أيلول الأسود" في شهر آذار/مارس 1973، عميلاً إسرائيلياً في 9 نيسان/أبريل جرت محاولتان في العاصمة القبرصية، إحداهما ضد مقر سفير الدولة الصهيونية والثانية ضد طائرة تابعة لشركة العال كانت جاثمة في المطار. على أن ما وصف بأنه رد إسرائيلي، كان صاعقاً. فغداة اليوم التالي لهذا الهجوم المزدوج الذي يتصادف مع الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة دير ياسين نزلت وحدة مغاوير إسرائيلية في بيروت واغتالت ثلاثة من قادة المقاومة الرئيسيين هم/ يوسف النجار (أبو يوسف) كمال عدوان وكمال ناصر.
هكذا قتلوا أبو يوسف وعدوان وكمال ناصر
كنت وثيق الصلة بكمال ناصر، وإلى جانب اجتماعاتنا السياسية، فإننا كنا نرى بعضنا مرة على الأقل في اليوم، مؤثرين أن يكون ذلك في الليل عندما يتوافر لكلينا الوقت، فنتحادث ساعات طويلة. كان كمال شاعراً مجيداً، يشع ذكاء وحساسية وطيب مزاج، ويعرف كيف ينشد يأس شعب منهك، وكيف يغني آمال المقاومة. وكان إنساناً تأتلف فيه الروحانية والدعابة. وكنت أحب فيه نزاهته العميقة وأمانته كمناضل.
وبرغم تعاطفه مع فتح إلا أنه لم ينتسب إليها لأنه لم يكن يفق مع حركتنا اتفاقاً دائماً كاملاً. وإنما كان يمارس وظيفته كناطق وحيد باسم منظمة التحرير الفلسطينية، بصفته شخصية مستقلة.
كانت محادثاتنا التي لا تنتهي تدور في الغالب حول مشكلة تمسك بشغاف قلوبنا: عنيت وحدة الحركة الفلسطينية. فكان هذا يقودنا إلى إثارة مزايا وعيوب المقاومة ووسائل تصحيح الانحرافات أو الأخطاء المرتكبة. وكم من مرة لعبنا دور الوسطاء أو دور الساعين بالمصالحة.
وقبيل الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة كمال ناصر ويوسف النجار وكمال عدوان بنحو من عشرة أيام، كنا بضعة أشخاص – بينهم هؤلاء الثلاثة وياسر عرفات – مجتمعين في شقة كمال. وكان الشهداء العتيدون الثلاثة يقطنون المبنى نفسه: كمال عدوان في الطابق الثاني وكمال ناصر في الثالث ويوسف النجار في السادس. فهل تراني توجست يومذاك غيابهم المأساوي؟ يبقى أني حين لاحظت لدى وصولي عدم وجود حرس أو أي تشكيل أمني، فإني قلت لهم بلهجة تتراوح بين الجد والهزل: "أما إنكم لمتهورون! لن تلبث أن تحط طائرة هيلكوبتر إسرائيلية في الأرض البور المراجهة لبمناكم ثم تختطفكم ثلاثتكم!" وانقلب قولي إلى ممازحة قبل أن يعود عرفات إلى الموضوع ليطلب إليهم أن يسهروا بصورة أكثر جدية على أمنهم. فأجابوا بأنهم لا يريدون إزعاج الجيران بإقامة حماية ملفتة كثيراً في المبنى.
وتشاء المصادفة أن يقرر مجلس منظمة التحرير المركزي، الذي كنا ننتمي إليه خمستنا، أن ينعقد بصورة استثنائية في بيروت – وليس في دمشق كالعادة – في يومي 9 و10 نيسان/أبريل (تاريخ الغارة الإسرائيلية) وطال اجتماع يوم 9 إلى ساعة متأخرة من الليل نمت بعدها، كما كان يحدث لي كثيراً – لدى كمال ناصر. وعلى أثر جلسة صباح اليوم التالي، عرض النجار وعدوان وناصر علي أن آتي فأتغذى معهم في مطعم على شاطىء البحر اشتهر بطيب السمك فيه. والواقع إنني كقاعدة عامة، أتلافى، أسباب أمنية، ارتياد المحلات العامة. ولا أدري أية نزوة دفعتني ذلك اليوم إلى قبول الدعوة: وعى كل، فقد أحسست بحاجة إلى أن لا أنفصل عن رفاقي الثلاثة ولو لساعتين. وبعد أن تناولنا وجبة كانت لذيذة على نحو خاص، وسادها طيب المزاج، ذهبنا معاً إلى المجلس المركزي الذي انتهت مداولاته في الساعة التاسعة مساء.
وعاد يوسف النجار وكمال عدوان إلى منزليهما. فعرضت على كمال ناصر أن ننهي السهرة في شقته. إلا أنه أجابني، أمام عظيم دهشتي، بلهجة مزاح: "أفضل أن أموت على أن أستقبلك عندي!" ثم راح يوضح لي بعد ذلك بجدية أن عليه أن ينظم مرثاة في الشاعر عيسى نخلة الذي مات لتوه، وأنه متيقن من أن وجودي سيمنعه من العمل. وإذاً فقد تركته آسفاً. ثم تذكرت أن علي أن أزور الناجين الثلاثة من عملية ميونيخ، فقررت أن أذهب لأسمع حكاية مغامرتهم. وحين وصلت إلى مقصدي، لاحظت وجود هرج قتال في الشارع حول المبنى الذي تحتله الجبهة الشعبية الديمقراطية التي يرئسها نايف حواتمه، والذي يقع على بعد نحو من عشرة أمتار من المبنى الذي ينزل فيه الفدائيون الثلاثة. وحين سألت بعض مناضلي الديمقراطية عن سر الهرج، قالوا إن مغاويرهم مستنفرون بسبب الهجوم الوشيك الذي ستشنه الجبهة الشعبية التي يرئسها الدكتور جورج حبش على مكاتبهم. واستشطت غضباً، وعبرت لهم عن رأيي في هذا الخلاف الأخرق بين منظمتين من منظمات المقاومة، ممن تقضي طبيعة الأمور عليهما بأن يكرسا جهودهما لمحاربة العدو.
وبطبيعة الحال فإني لم أكن أعلم في تلك اللحظة كم أن الحداث ستصوب قولي. فقد كانت الساعة آنذاك التاسعة والنصف، ولم يكن في تخيل أحد، أن المغاوير الإسرائيليين، وليس مغاوير الجبهة الشعبية، سيقومون بعد ثلاث ساعات بمهاجمة مبنى الجبهة الديمقراطية. غير أن أنصار نايف حواتمه كانوا قد وضعوا في هذا المبنى المؤلف من تسعة طوابق، دوائرهم الإدارية والمالية والإعلامية وجزؤاً هاماً من محفوظاتهم، منتهكين بذلك أدنى القواعد الأمنية الأولية.
ثم إن المحادثة التي أجريتها بعيد ذلك مع الناجين الثلاثة من عملية ميونيخ، أبعدتني عن مشاغلي الآنية المباشرة. فالتفاصيل التي زودني بها عن سير العملية شغفتني. كما أن السرد الذي سردوه لي عن التعذيب الذي لاقوه في السجون الألمانية بلبل خاطري. ذلك أن التنكيل الذي نزل بأحدهم، أورثه عاهة جنسية دائمة. ثم إن الثلاثة راحوا بدورهم يسائلونني عن الأوضاع السياسية. وفجأة سمعت صوت عيارات نارية. فنظرت إلى ساعتي فوجدتها تشير إلى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل. ووجدتني أنرفز مرة ثانية وأنا افسر لصحابتي أن المعركة الجارية هي على الأرجح معركة بين أنصار حبش وحواتمه.
وتكاثفت الطلقات، ثم جاءت أصوات انفجارات قوية لتزرع الريبة في رأسي. فقد كان ثمة مطر ينهمر من القذائف التي تتساقط على مبنى الجبهة الديمقراطية. وقلت في نفسي إنه من غير المحتمل بل من المستبعد أن يلجأ المهاجمون إلى مدافع الهاون. وبدأت أخمن الحقيقة عندما ظهر بواب المبنى الذي كنا فيه فجأة أمام باب شقتنا وهو يصيح بصوت مخنوق: اليهود! اليهود هنا!. وكان يرتجف من رأسه إلى أخمص قدميه بحيث أنه لم يستطيع أن يضيف إلى هذه الكلمات شيئاً.
وإذن، فإن التنبؤ الذي نبأت به لعشرة أيام خلت، دون أن أكون كثير الإيمان به، قد تحقق. فالإسرائيليون قائمون على أبوابنا بالمعنى الحرفي للكلمة. وقلت في نفسي إنهم إذا كانوا قد عرفوا كيف يحددون مقر الجبهة الديمقراطية، أفلا يعرفون كذلك، أن فدائيي ميونيخ الثلاثة يقطنون المبنى المجاور لمقر الديمقراطية؟ وأن ياسر عرفات يقطن هو الآخر في منزل يقع على بعد بضعة أمتار من مبنى الجبهة الديمقراطية؟
ولما كنا مسلحين بمسدسات جيب بسيطة، فإنه لم يكن في وسعنا – صحابتي الثلاثة وأنا – أن نفعل شيئاً يذكر، اللهم إلا أن نلجأ إلى قفص أو بئر سلم المبنى على موازاة الطابق الرابع. وأوصل أحدنا المصعد إلى الطابق الخامس ثم جمده هناك بأن فتح بابه، وهكذا يصبح المهاجمون مضطرين للصعود على أقدامهم والتعرض لنيراننا فقد كنا عازمين على المقاومة حتى آخر طلقة نملكها.
ثم إن حريقاً قوياً تبعته سلسلة من أصوات التقصف والتحطم جعلتنا نفترض أن مبنى الجبهة الديمقراطية قد تعرض للنسف. ثم تباطأت أصوات تبادل العيارات النارية. ونزل صحابتي إلى الشارع يترصدون المغاوير الإسرائيليين بينما كانوا ينسحبون مغطين انسحابهم بإطلاق النار متقطع.
وكان أعداؤنا يرتدون لباس الفدائيين ولكنهم كانوا يتبادلون الكلام بالعبرية. ثم نزلت بدوري إلى الشارع فتعرفت على الجثث الممددة على أرض المبنى والتي تعود إلى المناضلين الثلاثة الذين ينتمون إلى الجبهة الديمقراطية والذين وبختهم قبل ذلك بثلاث ساعات عندما علمت أنهم يتأهبون لقتال مغاوير الجبهة الشعبية. ما رفاقهم الذين كانوا في المبنى لحظة الهجوم فإنهم سلموا في غالبيتهم ذلك أنهم لحسن الحظ، غادروا المبنى قبل تدميره ليردوا على المهاجمين.
واجتزت الشارع وذهبت إلى منزل عرفات الذي كان سليماً هو الآخر. وعلمت أن الإسرائيليين قصفوا المبنى الذي يقيم فيه، غير أنهم، بالنظر إلى عدم تيقنهم من وجوده به، فإنهم لم يلجوا في القصف خاصة وأن حرسه قاوموا مقاومة صريحة. وافرج عن بعض الفدائيين الذين كانوا مسجونين في الطابق الذي يقع تحت أرض المبنى لارتكابهم بعض المخالفات. وسلحوا في بداية المعركة فأسهموا في رد الجنود الإسرائيليين. أما عرفات فتابع المعركة من سطح المبنى وهو يصدر تعليماته للمقاتلين.
صلبوا كمال ناصر وخرموا فمه بـ 15 رصاصة!
ولما كان قد بلغ عرفات أني كنت إبان المعركة موجوداً في مبنى مجاور، فإنه كان مقتنعاً بأني قتلت. ولهذا فإنه حين تلقاني احتضنني طويلاً بين ذراعيه. كان بادي الانفعال، وأطلعني على الأخبار التي وصلته: فالمغاوير الإسرائيليون الذين نزلوا في الجنوب قرب صيدا وفي بيروت قد شنوا هجماتهم على عدة أهداف فلسطينية في آن معاً. وأضاف عرفات: على أن أجسم ما في الأمر، هو أنهم دخلوا شقة يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر، ولكنه لا يدري ما إذا كان هؤلاء قد اختطفوا أم قتلوا. وبعد ذلك بدقائق بلغنا النبأ الصاعق: فرفاقنا الثلاثة قتلوا حقا وصدقاً.
وقررت لفوري أن أذهب إلى شارع فردان حيث يقع مبنى المعذبين الثلاثة. وبالنظر إلى المخاطر التي كانت لا تزال قائمة بالنسبة للتنقل في المدينة، فإن عرفات حاول أن يردعني عن ذلك ولكن دون جدوى. وكان أن أصابني المشهد الذي كان ينتظرني في مسكن كمال ناصر بالهلع. فقد رأيت صديقي – عبر غيمة من الدخان المتولد عن صاروخ أطلقه الإسرائيليون قبل اقتحامهم المنزل بلحظات – ممدداً في وضعية المصلوب. وكان محيط فمه يبدو وكأنه مخرم بخمس عشرة رصاصة على الأقل. فقاتلوه لم يهملوا الرموز، في عجالة مهمتهم المشؤومة، ولم ينسوا أن كمال مسيحيي الطائفة وناطق باسم منظمة التحرير الفلسطينية. وبخلاف ذلك فإن المهاجمين رشوا بالرصاص سريره والسرير الموضوع في غرفة الجلوس الذي كن آوي إليه عامة، وذلك للقاء على كل من يمكن أن يكون قد التجأ تحتهما.
كان كمال يلبس بيجاما، مما يشير في الظاهر إلى أن الهجوم فاجأه في نعاسه في اللحظة التي كان يهم فيها بالرقاد. وكان شباك نافذته مفتوحاً والستائر البندقية اللون منتزعة، ما لو أنه حاول الفرار في البداية. ثم أنه رد بعد ذلك بواسطة مسدس جيب وجدناه إلى جانبه. إلا أن مقاومته لم تطل لأن المسدس كان ينقص رصاصتين فقط. وعندها تذكرت أني كنت كثيراً ما أنا كده وأقول له: "إن أنت إلا شاعر ولن تستخدم السلاح في حياتك مطلقاً!" ولعلي لم أخطىء كثيراً في ذلك. أفلم يمت في اللحظة التي كان ينظم فيها مرثاة؟!
ونحن نعرف ظروف اغتيال رفيقينا الآخرين معرفة أوفى، بفضل شهادات أفراد أسرتهم. فقد قتل المغاوير الإسرائيليون الفدائي الوحيد الذي كان يحرس مدخل البناية بواسطة مسدس كاتم صوت، قبل أن يصعدوا بالمصعد إلى الطابق السادس. ونسفوا بوابة مدخل بيت النجار بواسطة قنبلة بلاستيكية. وكان رفيقنا وهو الذي يحب التبكير في الرقاد، قد نام، في حين أن أبناءه وهم صبي عمره ست عشرة سنة اسمه يوسف، وأربع بنات، يذاكرون دروسهم في غرفهم. وركض يوسف إلى مدخل البيت وواجه المغاوير الإسرائيليين الذين صرخوا فيه بالعربية: "قل لنا أين أبوك"؟ فاستبد الرعب بالصبي وأسرع إلى غرفته ثم خرج من النافذة وهبط إلى الطابق الخامس متسلقاً على قسطل، والتجأ هناك. خلال ذلك استيقظ النجار على الهرج وأقفل على نفسه في الصالون الذي يفصل غرفته عن المدخل. وبينما كان المغاوير يحاولون اقتحام الباب طلب إلى زوجته أن تناوله مسدسه. ودوت بعض الطلقات خلف الباب فانتهى به الأمر أن انفتح. وأصيب النجار إصابة خطرة فراح يترنح وهو يشتم المعتدين عليه صائحاً: "جبناء خونة" وحاولت امرأته أن تحميه بأن وضعت نفسها بين زوجها وبين الإسرائيليين. لكن هؤلاء واصلوا إطلاق النار ببرود وقتلوا الزوجين معاً.
وخلال هذا الوقت، احتلت شقة كمال عدوان الواقعة في الطابق الثاني. وكان كمال لا يزال يعمل، فتنبه إلى وجود ضجيج مشبوه على السلم. ولم يكد يمسك ببندقيته الرشاشة حتى بدأ المهاجمون باقتحام باب الدخول. وحتى قبل أن يتمكن من الرد تلقى عدة رصاصات... في رقبته، ذلك أن مجموعة ثانية من المغاوير الإسرائيليين تسللت إليه من نافذة المطبخ متسلقة المجارير الخارجية، وأطلقت عليه النار في ظهره. أما زوجته وولده فقد كانا يشاهدان المشهد البشع وهما عاجزان عن إتيان أي أمر، فإن الإسرائيليين أبقيا عليهما، ثم توجهوا نحو الطابق الثالث ليقتلوا ضحيتهم الثالثة، كمال ناصر.
ومن البديهي أن مغاوير الجنرال دايان – الذي كان حينذاك وزيراً للدفاع – ما كانوا يستطيعون القيام بعملية استغرقت قرابة الثلاث ساعات في قلب بيروت، دون أن يعترضهم رقيب أو حسيب، لولا تمتعهم بتواطؤ شركاء محليين هامين.
حذر في العائلة تجنباً لمؤامرات الاغتيال
وبعد أن روى أبو أياد تفاصيل محاولات جرت لاغتياله وتصفيته، أشار إلى محاولات جرت للاعتداء على حياة أقاربه.. فقد تلقى أولاده مرتين علب شوكولاتة كانت في الحقيقة ملغومة ولحسن حظهم أن أبو أياد وزوجته علماهم أن يكونوا متيقظين وعلى جانب من الحذر بحيث يمتنعون حتى عن فتح طرود الحلويات التي يبعث بها هو إليهم حين يكون في الخارج، ويقول أبو أياد:
"مع أنني مهدد دائماً، إلا أنني لا أخشى الموت. وأنا مؤمن دون أن أكون صوفياً. والرعاية الإلهية التي أبقت علي حتى الآن، لا تعفيني من اتخاذ حد أدنى من الاحتياطات لأؤمن سلامتي وسلامة ذوي.
ولما كنت من الجهة الثانية، شديد النفور والكراهية لإراقة الدم، فإنني جاهدت أبداً لأمنع شباب المقاومة المتحمسين من القيام بمحاولات اغتيال أعتبرها غير مجدية أو مضرة بقضيتنا.
غير أنه كان لحرب تشرين أول/اكتوبر كنتيجة، أنها قدمت السياسة على العنف، تقديماً مؤقتاً، على الأقل.
أسرار عملية الدفرسوار وموقف السادات
ويستعرض أبو أياد في مذكراته تفاصيل اجتماعاته بالرئيس المصري أنور السادات قبيل حرب تشرين/اكتوبر، وتفاصيل ما جرى من اتصالات ومشاورات ومعارك وأدوار.. ويركز أبو أياد في مذكراته على ثغرة الدفرسوار الشهيرة ويقول بصدد ذلك:
"إن تاريخ حرب تشرين/اكتوبر لم يكتب بعد، برغم ذلك العدد من المؤلفات الجيدة التي كرست له. فالواقع أن بعض التقلبات لا تزال في الظل، كما أن عدداً آخر منها يشكل ألغازاً لم تفك رموزها بعد. وأحد هذه الألغاز، وهي ليست من أصغرها شأناً، هو بلا نزاع، عبور رجال الجنرال شارون قنال السويس بواسطة عملية اختراق قلبت مجريات الأحداث وأنهت هزيمة الجيش المصري.
فلا زلت إلى اليوم أجد في سلوك القيادة المصرية العليا. وفي سلوك السادات نفسه، إزاء محاولة الجنرال شارون أمراً يعصي على التصديق. وليحكم من شاء على ما سأقول. ففي العشرين من تشرين الأول، أي قبل أربعة أيام من قيام وحدات المغاوير الإسرائيلية بعبور القنال عند نقطة تعرف باسم الدفرسوار، قريبة من البحيرة المرة الكبرى (التمساح) قام عملاء المخابرات المصرية المتنكرون بثياب بدوية، بإرسال إشارة إلى القاهرة (بواسطة أجهزة إرسال) تفيد بمرور جسور ودبابات برمائية في العريش. فطبيعة هذا العتاد نفسه بحد ذاتها برهان على أن الجيش اليهودي سيحاول اجتياز القنال وتطويق الجيش الثالث المرابط على الضفة الشرقية للقنال، كما أن قيادة الأركان في القاهرة تملك في ملفاتها عدة مخططات، أعدت منذ أيام عبد الناصر أو منذ عهد قريب بهدف تلافي حدوث عمليات اختراق في أربع نقاط ضعيفة على الأقل، بينها نقطة الدفرسوار بالتحديد. وإذن فإنه ليس في الخطة الإسرائيلية شيء غير متوقع. فماذا فعلت القيادة المصرية العليا؟ لا شيء. كما أن المعلومات التي وردت من العريش في 10 تشرين ول لم تبلغ في ظاهر الأمر للسادات.
وبعد ذلك بيومين، وبعد أن وصلت طليعة قوات الجنرال شارون غلى منطقة الدفرسوار، جاء النفير الثاني، ولكن من جانب ممثلينا هذه المرة. فقد قام قادة جيش التحرير الفلسطيني ووحدات فتح المكلفة مع الجيش الكويتي بالدفاع عن الدفرسوار، بإبلاغ القاهرة بوشوك الهجوم الإسرائيلي. إلا أن المسؤولين المصريين لم يقوموا بأي رد فعل ولم يرسلوا بتعزيزات للدفاع عن هذه النقطة الحساسة العصيبة. وفي يوم 14 تشرين أول انتقل الجنرال شارون إلى الهجوم وتمكن من تسريب بضع دبابات وراح يحاول توسيع الثغرة. فقاتل رجالنا ببطولة وسقطوا في ساحة الشرف بالعشرات. كان لوضع عصيباً ولكنه لم يكن يائساً. فلا يزال في الوقت فرصة لكي تتخذ القيادة المصرية العليا إجراءات ترد العدو على أعقابه. ولكنهم تركوا الأمور تجري على هواها. أما السادات الذي ألقى في 16 تشرين أول خطاباً متلفزاً تحدث فيه عن نجاحات جيشه فلم ينبس بكلمة حول المعارك الجارية على ضفتي القنال. وهو لا يمكن ألا يكون على علم بالكارثة لأني أنا نفسي كنت على علم كامل بالوضع.
فكيف نفسر سكوت وسلبية قيادة جيشه العليا؟ إن السر لا يزال كاملاً، هذا ولم تكد الحرب تنتهي، وبينما كان الجيش الثالث لا يزال محاصراً، حتى كان السادات يريد أن يبدأ التفاوض مع إسرائيل. وفي 26 تشرين أول، أي بعد مرور ثمانية وأربعين ساعة على وقف النار الثاني، حدد لنا محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير الأهرام، الذي كان أحد مستشاري الرئيس المصري المسموعين في تلك الحقبة، موعداً لمقابلة هذا الأخير في اليوم نفسه. واستقبلنا السادات في قصر القاهرة. وقبل أن نتمكن من الجلوس – فاروق القدومي وأنا – سألنا فجأة: "وإذا، هل تقبلون بالاشتراك في مؤتمر السلام؟".
كان السادات يبدو قلقاً ومعيل الصبر في آن معاً. ففي خطاب 16 تشرين أول، أشار إلى أن "الفلسطينيين" يجب أن يشركوا بالضرورة في عملية السلام. أما اليوم فإنه يريد أن يعرف ما إذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية توافق على تمثيل الفلسطينيين حول الطاولة المستديرة. وقلت له إننا لا نستطيع الإجابة عن سؤاله قبل أن نطلع اطلاعاً واسعاً على حيثيات الموضوع. ونحن نريد أن نعرف ماذا سيكون مؤتمر جنيف بالضبط، ووفق أية شروط سوف ندعى إلى حضوره والمشاركة فيه. وقدم لنا الرئيس المصري بعض التوضيحات: فقد كتب إلى الحكومتين الأميركية والسوفياتية ليعرض عليهما المشاركة في الاجتماع وليقترح مشاركة فرنسا وبريطانيا كذلك، إلى جانب مصر وسوريا والأردن والفلسطينيين، ثم بطبيعة الحال، إسرائيل. وأضاف في رسالته أن المؤتمر يجب أن ينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك أو في جنيف حيث تملك الأمم المتحدة مكاناً لهذا الغرض. ثم أردف من باب طمأنتنا: وأي سوء في هذا طالما أن الدبلوماسيين العرب يقابلون عادة ممثلي إسرائيل في مختلف محافل المنظمة الدولية.
واعترضنا قائلين إن منظمة الأمم المتحدة مكلفة بتطبيق قرار جلس الأمن رقم 242 الذي جرى تبنيه في 22 تشرين ثاني/نوفمبر عام 1967. وهو القرار الذي نرفضه نحن لأنه يسكت عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. ولهذا فإن ذهابنا إلى جنيف أو إلى نيويورك ضمن هذه الشروط. يعني أننا نقبل التفاوض على إعادة حقوق "اللاجئين" كما يشير إليهم القرار 242. وراح السادات يحاول إبعاد اعتراضنا بالإعلان علينا "ليس عليكم إلا أن تتجاهلوا هذا القرار. تعالوا وأعرضوا وجهة نظركم وأعرضوا مطالبكم، أية كانت هذه المطالب. دافعوا إذا أردتم عن أطروحتكم حول ضرورة تفكيك دولة إسرائيل كمقدمة لإقامة فلسطين ديمقراطية متعددة الطوائف. فالأمر الضروري هو أن تكونوا حاضرين في مؤتمر السلام!".
فوعدناه بأن نعرض اقتراحه في أقصر مدة ممكنة على الهيئات العليا في المقاومة. وبانتظار ذلك، فإننا طرحنا عليه عدة أسئلة حول الوضع العسكري، لماذا قبل بوقف إطلاق النار بمثل هذه السهولة؟ هل كانت ثغرة الجنرال شارون بمثل هذا القدر من الخطورة والتهديد؟ وحاول السادات أن يقلل من أهمية الثغرة مؤكداً أن الجيش الثالث ليس مهدداً بالإبادة. غير أنه ذكر بالمقابل قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بشحنات من الأسلحة البالغة التطور خلال المرحلة الأخيرة من القتال، و"تخلي" الاتحاد السوفياتي الذي يرفض تزويده بالسلاح الضروري لمواصلة الحرب. وبدت لنا الحجة التي أدلى بها لإقناعنا بعجزه، حجة مشتبهة. فالقوات المصرية شنت القتال – أولاً – بسلاح سوفياتي ذي كم وكيف، أكثر من كافيين. وثانياً – لأنني كنت أنا نفسي أسكن قرب مطار الماظة الحربي (في ضاحية القاهرة) وتمكنت أن ألاحظ بعيني اتساع وكثافة شحنات الأسلحة السوفياتية طوال حرب تشرين. ووفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن – وهو معهد لا يمكن أن يتهم بمحبة السوفيات – فإن الجسر الروسي الذي أقيم مع مصر وسوريا اشتمل على 934 رحلة طيران ذهاباً وإياباً. هذا بدون أن نحسب الشحنات التي تمت بطريق البحر وأفرغت في الموانىء المصرية. وبدون أن نتكلم عن الموارد الإلكترونية التي أشركتها موسكو في جمع الاستخبارات عن تحركات القوات الإسرائيلية. وفي يوم 26 تشرين أول، أي في ذات اليوم الذي أجرينا فيه المحادثة مع السادات، كشف هنري كيسنجر النقاب عن أن الاتحاد السوفياتي قد عزز تعزيزاً عظيماً أسطوله الحربي في المتوسط، ووضع عدة وحدات مجوقلة (محمولة جواً) في حالة استنفار. فكان الروس بذلك يريدون ردع إسرائيل عن مواصلة هجومها ضد الجيش المصري الثالث.
القذافي قدم كل المعونة: مالياً وعسكرياً
واشتكى السادات كذلك بمرارة من العقيد القذافي الذي أخذ عليه علناً السلوك الذي سلكه في الحرب والأهداف المحدودة التي رسمها لها. هذا مع أن الرئيس الليبي لم يدخر وسعاً في تقديم معونته المالية والاقتصادية والعسكرية له، على الرغم من عدم اتفاقه معه. فهو لم يقدم لمصر عملات صعبة بالنقد السائل ونفطاً وحسب، بل وكذلك طائرات "ميراج" اشتراها من فرنسا وسبعين طائرة ميغ 21، بينها 26 طائرة اشتراها بأن الاشتباكات وأرسلت مباشرة من الاتحاد السوفياتي إلى الجبهة المصرية. ومنذ الساعات الأولى للحرب، أرسل القذافي إلى القاهرة عضوين من أعضاء مجلس الثورة هما الرائد عبد المنعم الهوني والرائد عمر المحيشي وظلا هناك تحت تصرف السادات، تحسباً لحالة احتياجه إليهما. وهكذا فإنهما أخطرا طرابلس "بثغرة" شارون موضحين أن هذه النكسة قد نالت كثيراً من الرئيس المصري. فما لبث الرائد عبد السلام جلود، رئيس الوزراء الليبي السابق، إن ركب الطائرة إلى القاهرة وأبلغ القذافي أثر محادثة مع السادات بأن هذا الأخير "منهار" معنوياً.
وقام الرئيس الليبي بدوره بزيارة القاهرة حيث وجد السادات ملازماً سريره ويعاني أوجاعاً في المعدة وعاجزاً، فيما يبدو عن خوض محادثة متماسكة. وعرض القذافي وهو يتحرق برماً وعيلان صبر، بأن يذهب بنفسه إلى المقر العام للقوات المسلحة، لمتابعة تطور المعارك. فرفض السادات رفضاً قاطعاً مؤكداً له أن جنرالاته أهل تماماً للقيام بمسؤولياتهم. والحقيقة هي أنه لم يكن يريد له أن يتدخل بمشروع ندد به بشدة.
وفي ختام الفصل الذي يحمل عنوان "شرارة أكتوبر" وفيه ما فيه من التفاصيل والأحكام والأسرار، قال أبو أياد:
"لم تكن حرب تشرين بالنسبة إلينا نحن الفلسطينيين، كما بالنسبة إلى جميع الأمة العربية، إلا انقشاعة قصيرة الدوام. وبدلاً من أن تشق طريق تحرير الأراضي المحتلة فإنها عززت النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط ويسرت مؤامرات تصفية المقاومة الفلسطينية. وبالمقابل، فإن الحرب ونتائجها أثارت في صفوفنا وعياً صحياً سيساعدنا على تكييف أهدافنا على الحقائق، وعلى اتخاذ قرارات جريئة تضع حداً نهائياً لسياسة " كل شيء أو لا شيء".
ثم يمضي في الفصل الثامن (تحدي السلام) في رواية أسرار الاتصالات السياسية وتأثيرات دبلوماسية الملوك التي اتبعها كيسنجر، والملابسات التي أحاطت بمؤتمر القمة العربي الذي انعقد في الرباط، وأورد تفاصيل ما أشارت إليه الأنباء عن مجموعات الفدائيين التي كانت مكلفة بتصفية عدد من الرؤساء والملوك العرب.. ثم أشار إلى الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وإسرائيل لفك ارتباط الجيشين... ثم – كما قال أبو أياد – صار في مستطاع الجنون الدموي أن ينفلت من عقاله في لبنان...
هكذا تم اغتيال السفير الأميركي في لبنان
وفي الفصل التاسع من المذكرات.. الفصل الذي جعل أبو أياد عنوانه "الشرك اللبناني" أوسع التفاصيل والمعلومات والأسرار عن الحرب اللبنانية وخفاياها.. وإذا كانت الإشارة إلى تفاصيل المحتويات أو إلى أبرز عناوينها تشكل بحد ذاتها إثارة وتأثيراً فإن ما يمكن أن نأخذه من هذا الفصل يقتصر على صفحتين فقط من المذكرات وردت فيهما تفاصيل اغتيال السفير الأميركي في لبنان فرنسيس ميللوي.. وهذه هي التفاصيل كما أوردها أبو أياد:
"ارتكبت الجريمة الغبية النذلة في 16 حزيران/يونيو. ففي هذا اليوم كان سفير الولايات المتحدة الجديد في بيروت فرنسيس ميللوي، الذي لم يكن قد مضى عليه في منصبه هذا سوى شهر، ومعه المستشار الاقتصادي في السفارة روبرت وارنغ في طريقه لمقابلة الياس سركيس الذي لم يكن قد بدأ يضطلع بعد بمهمته الرئاسية بانتظار نهاية ولاية سليمان فرنجية. وكان لا بد للدبلوماسيين من سلوك طريق المتحف، الطريق الوحيدة التي تصل القطاعين المتناحرين من بيروت، عنيت القطاع الغربي الذي تقع فيه السفارة الأميركية، والقطاع الشرقي الذي تسيطر عليه الميليشيات المارونية ويقطنه الرئيس المنتخب.
ووصلت سيارة السفير تتبعها سيارة الحرس إلى الخط الفاصل بين القطاعين. ولدى وصولها إلى مدخل شارع المتحف انعطفت سيارة الحرس متخلية عن السيارة التي تقل السفير ومستشاره الاقتصادي. لكن لماذا؟ إن السر لا يزال يكتنف هذه القضية ولم يكتشف حتى الآن. يبقى أن سيارة السفير اختفت قبل أن تصل إلى حاجز المراقبة الواقع على نقطة تقاطع القطاعين. وبعيد ذلك بساعات اكتشفنا جثث فرنسيس ميللوي وروبرت وارنغ وسائقهما اللبناني زهير مغربي وقد اخترقها الرصاص. غير أن حزب العمل الاشتراكي العربي، وهو فصيل لم يسبق لنا أن سمعنا به قبل ذلك، أعلن تأييده لهذا العمل دون أن يدعي مسؤوليته عنه. وهذه هي كافة الوقائع التي تناهت إلى علم الرأي العام قبل أن يطوى ملف القضية.
وقررت من جانبي القيام بتحقيق حول الحادث. وبعد ثمانية أيام من البحث والتحري، أبلغت بوجود سيارة السفير في مرآب، فقامت مجموعة فدائية باقتحام المبنى وعثرت فيه على السيارة كما وجدت هناك شاباً في السادسة عشرة من عمره يتولى حراستها. ولم يكن المراهق أكثر من (كومبارس) إلا أنه زودني ببعض الإشارات حول مسير العملية. وهكذا فقد علمت أن القتلة اتصلوا بزهير مغربي، السائق الشخصي للسفير، قبيل تنفيذ جريمتهم ببضعة أيام لتأمين تواطئه معهم. فأكدوا له أنهم يريدون خطف رب عمله للحصول على فدية ثم يطلقان سراحه وسراح راكبي السيارة الآخرين. وكان خادم السفارة الأميركية الوفي الهرم هذا، يعيش حياة هي أكثر بؤساً وضنكاً من أن تحول دونه ودون أن تراوده الرغبة في الحصول على نصيب من الفدية يضمن له ولعائلته الأمان المادي لسنوات طويلة. وهكذا فقد قبل أن يلعب دور الأداة في يد الخاطفين. فأوقف السيارة عند نقطة اتفق عليها معهم. بحيث يتمكن الخاطفون من الاستيلاء على ضحاياهم دون إطلاق رصاصة. وبعد أن جرى استجواب ميللوي ووارنغ استجواباً يستطيع مخبري أن يفيدني عنه بشيء، جرى إعدامهما وإعدام مغربي معهما بكل برود. ثم غادر القتلة لبنان بعد ذلك بساعات دون أن يتركوا أي أثر.
لكن ما دام هؤلاء لم يطلبوا أية فدية، ولا تقدموا بأية مطالب سياسية أو سواها، فماذا كان هدفهم إذن؟ إن المراهق الآنف الذكر روى لي أنه استمع عرضاً إلى محادثة بين القتلة سمعهم يقولون فيها إنهم كانوا يأملون أن يترتب على عمليتهم، حدوث إنزال أميركي في لبنان! وإذ كان هؤلاء يرثون شأننا جميعاً لاقتتال الأخوة الفلسطينيين والسوريين، فإنهم كانوا يتصورون أنه سيسعهم وضع حد له بتحويل لبنان إلى فيتنام جديدة وتطوير الحرب الأهلية إلى حرب تحرير وطني! ولا ريب في إنه يحق لنا أمام منطق بمثل هذه البساطة الشائنة، أن نتساءل ما إذا كان مرتكبو هذه العملية الغبية أشخاصاً حمقى أم عملاء مأجورين!!".
ويخصص أبو أياد الفصل العاشر والأخير للحديث عن رحلة أنور السادات إلى إسرائيل وخفايا وملابسات هذه الزيارة وأسرار الاجتماعات التي سبقتها والتي هيأت لها..
ونترك تفاصيل كل ذلك لينشر في حينه مع ما يمكن أن يطرأ من أحداث منذ الآن نلقي الضوء على كل ما جرى ويجري.. ونأخذ عن أبو أياد أحاسيسه يوم تلك الزيارة إذ وصفها قائلاً:
اليوم يوم 19 تشرين ثاني/نوفمبر 1977.
وطائرة البوينغ الراسية تحط بهدوء في مطار تل أبيب، وأنا جالس أمام جهاز التلفزيون في بيروت، أراقب الجمهور الكثيف من الشخصيات الإسرائيلية ذات الوجوه المألوفة مني أو غير المألوفة، وهي تنتظر وصول السادات. واستقرت الطائرة أخيراً وبدأ المصورون، والأشخاص المجهولون، ورجال الأمن بالثياب المدنية، والموظفون يهبطون مسرعين. وكوكبة من القادة الصهاينة يتقدمهم مناحيم بيغن واقفون كالخشب المسندة على قدم سلم الطائرة ونظراتهم مسمرة على بابها الفاغر. وأنا يغمرني أمل مجنون في أن السادات لن يخرج من الباب! لأنه قرر في اللحظة الأخيرة ألا يأتي إلى إسرائيل!
وتلقيت الصدمة في أحشائي وأحسستها تشنجاً في حلقي. ذلك أن الرئيس المصري ظهر تحت أضواء كاشفات الضوء كالتماعة النور في الدكنة، وهو يصافح أيدي جلادي شعبنا وهم يتتالون أمام ناظري: بيغن، دايان، شارون، والجنرالات ببزاتهم. ثم ظهر السادات "المنتصر في حرب أكتوبر" جامداً أمام علم المحتلين بينما النشيد الوطني الصهيوني يدوي في الأسماع. وانسابت الدموع على خدود عدد من رفاقي. أما أنا فلازمت جهاز التلفزيون دون أن أحول ناظري عنه طوال أربعين ساعة، متتبعاً زيارة العار والمذلة دقيقة دقيقة.
المقاومة والصين
عن الرحلات إلى الصين قال أبو أياد في مذكراته:
"سبق لياسر عرفات أن زار بكين مرتين في العامين 1964 و1966، وكانت الزيارة الأولى ناجحة بحذر، بينما تمخضت الثانية عن وعود بالمعونة تجسدت بعد حرب الأيام الستة. والواقع هو أن عدة مجموعات من الفدائيين تلقت اعتباراً من العام 1968 إعداداً عسكرياً في معسكرات التدريب في الصين، إلا أنه بقي علينا أن ننمي ونعزز هذه العلاقات وقد كان هذا الهدف في بالنا حين سلكنا، ياسر عرفات وأنا، طريق بكين في شباط/فبراير 1970.
وكانت الدواعي السياسية والأمنية توجب أن تظل هذه الرحلة سرية، وإمعاناً في التمويه سلكنا طرقاً مختلفة لنلتقي في باكستان حيث نستقل الطائرة من هناك. وحاولنا أن لا نسترعي الانتباه، فكان عرفات مثلاً يلبس طقماً رسمياً مستبدلاً غطاء رأسه التقليدي (الكوفية والعقال) بقبعة لينة محترمة، لكنها كانت احتياطات لا طائل وراءها. إذ ما كدنا نجلس في الطائرة حتى وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه مع عبد السلام جلود – الشخصية الثانية في ليبيا – وكان بادي الإحراج وحيانا بقليل من الملاطفة ثم لزم الصمت طوال الرحلة. وعرفنا بعد ذلك أنه كان يقوم هو أيضاً بزيارة سرية للصين هي أول زيارة يقوم بها منذ قيام الثورة الليبية في أول أيلول/سبتمبر 1969.
وسحرنا شو آن لاي الذي أجرينا معه محادثات ودية طويلة بذكائه الحاد ورهافته وسعة ثقافته. ثم إن الأسئلة التي طرحها علينا نمت ليس عن عميق تعاطفه إزاء الشعب الفلسطيني وحسب وإنما عن عميق معرفته كذلك بالمشكلة وسياقها المحلي والدولي، وكان يتذكر بالتفصيل – وهو ذو الذاكرة الفريدة – الأجوبة التي حصل عليها من زوار فلسطينيين آخرين عن الأسئلة نفسها التي وجهها إلينا، الأمر الذي كان يتيح له أن يستخلص نتائجه الخاصة.
وعندما تعرضنا لموقفنا من الاتحاد السوفياتي – وهي أدق المسائل على الإطلاق – فإننا شرحنا له أننا نريد إقامة علاقات ودية مع موسكو. وأضفنا بأننا نأمل أن لا تنال مثل هذه العلاقات من تعاوننا مع الصين الشعبية. كان من البدهي أن النظام الصيني يريد – كما يظهر من الشعارات التي تغطي جدران بكين – تعبئة السكان ضد "إمبريالية الاتحاد السوفياتي الاشتراكية".
وأصغى إلينا شو آن لاي برصانة ثم أجابنا أمام عظيم دهشتنا بأنه يفهم شواغلنا "فأنتم تمثلون حركة تحرر وطني، ومن الطبيعي أن تحاولوا تأمين العون والمساعدة حيثما وسعكم الحصول على ذلك".
ووعدنا بدعم الصين الكامل ودعانا إلى توضيح حاجاتنا بدقة. ثم ضرب لنا موعداً لموافاته في اليوم التالي إلى وزارة الدفاع حيث أعلمونا للتو بأن طلباتنا العسكرية والمدنية قد قبلت".
الأزهر.. والثياب المسروقة!!
روى أبو أياد في مذكراته الحادثة الآتية:
"بعد ثلاث سنوات من خروجنا من فلسطين، غادرت غزة إلى القاهرة (العام 1951) بقصد انتساب إلى الجامعة. ووفقاً لما وعدوا به فإن أقاربي راحوا يكتتبون – كل حسب طاقته – ليزودني بما أعيش به. وبخلاف مباركة والدي، فإني تلقيت مبلغ خمسين جنيهاً ينبغي أن يفي باحتياجاتي خلال الأشهر الأولى. ثم إن أبي أوصى بي أحد أبناء عمومته ويدعى الشيخ يوسف وكان يتابع دروس علم الكلام في جامعة الأزهر. وجاء الشيخ يوسف إلى محطة القاهرة برغم عماه يسعى في طلبي، وعرض علي المبيت في منامة الجامعة. ومنامة الجامعة عبارة عن رواق تصطف فيه الأسرة بمحاذاة بعضها البعض فلا تفصل السرير عن الآخر سوى منضدة صغيرة. ولما ان أحد زملاء الشيخ يوسف غائباً، فلقد كان بوسعي أن أشغل سريره بضعة أيام إلى أن أعثر على مأوى دائم. وقبلت عرض ابن عمي بطيبة خاطر برغم نفوري من المنامة الوسخة لتي تنبعث منها رائحة بشعة.
ثم إني علقت قميصي ولباسي الذي دسست في جيبه الخمسين جنيهاً بمسمار. وعندما فتحت عيني في صبيحة اليوم التالي لاحظت أن ثيابي اختفت. وإذ استولى علي الذعر هززت الشيخ يوسف الذي كان ما يزال نائماً لأستوضحه ما حل بها، إلا أنه لم يكن يعلم أكثر مما أعلم، ولم يطل بنا الأمر حتى أدركت أن أمتعتي قد سرقت"..
فتح ومكافحة الجاسوسية
يقول أبو أياد في مذكراته:
"كانت لدينا ثغرة يجب سدها فأنشأنا دائرة لمكافحة الجاسوسية تولى قيادتها فاروق القدومي قبل أن تسند إلي في نهاية العام 1967. وتلقى بعض الكوادر الذين انتخبناهم بدقة إعداداً سريعاً في مصر وسواها قبل أن ينتشروا في الأرض المحتلة والبلدان العربية المجاورة.
ثم إن عدداً من المخبرين الذين عملوا لصالح البوليس الإسرائيلي تقدموا إلينا معترفين بذنبهم، فأعطيناهم بصورة عامة – بعد إجراء استجوابات كثيفة معهم – إمكانية التكفير وذلك إما بإلحاقهم بمخابراتنا الخاصة وإما عبر قيامهم بمهمات ذات خطورة خاصة. وكانوا يسجلون قبل الانطلاق في العملية تصريحاً حول نشاطاتهم السابقة لصالح إسرائيل ثم يعرضون أسباب تحولهم. وكنا نحتفظ بحق نشر تصريحاتهم في حالة موتهم أو إذا ما تبين أنهم عملاء مزدوجون، الأمر الذي لم يحدث أبداً.
وقد طبقنا منذ البداية قاعدة عدم المعاقبة على الخيانة بالإعدام. كنا نعدم فقط أولئك الذين أدى تعاونهم مع العدو إلى خسارة بشرية في صفوفنا. لكن هذه الحالات الأخيرة كانت نادرة نسبياً، ذلك أن عدد الذين أعدموا خلال عشر سنوات كان في حدود العشرين من الوشاة فقط.
أما المتعاونون مع العدو من أمثال الشيخ الجعبري، فلم نكن نتخذ ضدهم بصورة عامة أي عقاب، كان تقديرنا في الواقع أن من الأولى تحييدهم بعزلهم سياسياً عن الأهالي. وقد أخذ علينا بعض أصدقائنا في العالم الثالث أحياناً أننا لم نصفّ خصومنا جسدياً، وبذلك أسهمنا في تغذية الانقسامات والتشويش في الحركة الوطنية الفلسطينية. إلا أن قادة فتح كانوا يعتبرون دائماً وأبداً أن الحوار الديمقراطي هو الطريقة الصحيحة الوحيدة – والمجزية على المدى الطويل – من أجل امتصاص الخلافات.(انتهى)
_____________________________________________
Last Updated (Thursday, 10 March 2011 13:01)